بقلم: مهدي صادق أمين.
سلطة بوجهين
في فجرٍ محمّل برائحة البارود، وفي لحظة سياسية متفجّرة، خرج أحمد الشرع بخطابه الذي ظنّه البعض مصارحة، لكنّه في جوهره كان فصلًا جديدًا في مسرحية مُتقنة الإخراج… محاولة لإنقاذ سردية متهاوية، لا أكثر. فما بين الدخان المتصاعد من سماء دمشق بعد أعنف قصف إسرائيلي عرفته العاصمة منذ حرب تشرين، وبين جراح السويداء الغائرة التي ما زالت تنزف، كشف خطاب الشرع عن أزمة سلطة مؤقتة تتقدّم بوجهين:
أحدهما موجه نحو الداخل لإعادة الإمساك بالأرض المتفلّتة.
والآخر نحو الخارج في محاولة لتعديل شروط التفاوض تحت ضغط الدم والدمار.
فما الذي حدث فعلاً؟ ومن يحكم دمشق اليوم؟
وكيف تحوّلت السويداء إلى رأس جبل في خارطة نفوذ إسرائيلي صاعدة؟
وهل لا تزال سوريا بلدًا موحّدًا، أم باتت كيانًا رماديًا تتنازعه الوكالات والوظائف الإقليمية؟
مشهدية خطاب الشرع:
ما وراء الكاميرا
كلمة أحمد الشرع الأخيرة لم تكن خطاب مقاومة بقدر ما كانت محاولة لتجميل مأزق شامل.
الزاوية التي اختارتها الكاميرا، والماكياج الذي أخفى آثار إصابة “مُعلنة” على خده، ومفردات التحدي لإسرائيل، كلّها أدوات دعائية هدفها واحد: صناعة “زعيم يتحدى القصف” بينما تتهاوى السيادة تحت وقع الصواريخ.
الرسالة المقصودة لم تكن موجهة لإسرائيل، بل إلى الداخل المترنّح: “أنا هنا رغم الضربات”.
لكن السؤال الذي لم يُطرح: لماذا ضُربت دمشق بهذا الشكل؟
وهل كان الشرع حقًا يجهل موعد القصف، أم أن الأمر كان ضمن ترتيبات إقليمية تُدار في باكو وتُكتب في تل أبيب؟
انهيار التفاهمات مع إسرائيل:
بداية العضّ على الأصابع ما لم يقله الشرع بوضوح، قاله السياق: المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل تعثّرت والصفقة التي كانت تُطبخ على نار هادئة بين أجهزة إقليمية، بغطاء أميركي وبإشارات إيجابية من الشرع، انهارت فجأة.
الرد الإسرائيلي كان قاسيًا ومباشرًا، استهدف صلب النظام:
هيئة الأركان
القصر الجمهوري
المقار الأمنية
لا رسائل في الهامش هذه المرة، بل رسائل في القلب.
وبين سطور الخطاب، تسرّبت نبرة التراجع، لا التحدي.
ليس تهديدًا بالحرب، بل محاولة لإعادة التموضع في معسكر “الممانعة”، بعدما فشل الرهان على صفقة تُبقي الشرع في الحكم مقابل صمت على التمدد الإسرائيلي في الجنوب.
السويداء الأرض المحروقة والثمن السياسي
الدم الذي سال في السويداء لم يكن نتيجة خلل أمني أو تمرد منعزل، بل نتيجة قرار سياسي و”عملية تأديب” أرادها الشرع خاطفة ورسالة. لكن الأمور خرجت عن السيطرة، لتتحوّل المنطقة إلى ساحة مواجهة مفتوحة، وتفشل خطة “الصدمة والترويع” في إخضاع مجتمع درزي متماسك، يعرف كيف يقاتل، والأهم… يعرف لماذا يقاتل.
أحداث السويداء فضحت أمرين خطيرين:
1. هشاشة القوة المركزية الجديدة التي لم تفلح في تثبيت نفسها دون استخدام أدوات الإذلال الجماعي.
2. تحوّل الجنوب إلى منطقة رمادية بامتياز، حيث لا الدولة تحكم، ولا اللادولة تسيطر، بل منظومة نفوذ خارجي تتسلل بهدوء وتفرض وقائعها بالقطارة.
الجنوب السوري كيف تولد مناطق النفوذ؟
ما نشهده ليس مجرد تراجع للسلطة المركزية، بل ولادة نظام سيطرة جديد، تشرف عليه إسرائيل من خلف الستار، كما فعلت تركيا من قبل في الشمال.
لا احتلال مباشر، ولا وكلاء دائمون… بل وكلاء عابرون، يُمنحون:
الغذاء
السلاح
الماء
مقابل الولاء الكامل.
في “مدينة البعث” بالقنيطرة، تُبنى الآن البنية التحتية لمنظومة السيطرة الجديدة:
مراكز إغاثة
شبكات تمويل
نقاط تجنيد
توزيع مياه
لم تعد السيطرة تعني الدبابات، بل المنظومات البديلة التي تُخضع السكان من خلال حاجاتهم اليومية.
من السويداء إلى درعا، فالقنيطرة، نرى تحوّلًا خفيًا في بنية السيادة: الدولة تبتعد، والوكلاء يتموضعون.
والشرع، في أفضل أحواله، مجرد واجهة لإدارة هذا الانحدار.
من يملك القرار؟ ومن يكتب السيناريو؟
منذ هروب الأسد واختفائه من المشهد، لم تُعلن دمشق عن رئيس مؤقت، بل تم فرضه.
أحمد الشرع لم يُنتخب، لم يُفوّض، ولم يُكلّف بموجب دستور… بل ظهر فجأة. هذا وحده كافٍ لنزع الشرعية عنه كقائد. لكن الأخطر أن قراراته تشير إلى تبعية واضحة، لا لإيران كما كان يُتّهم من سبقوه، بل لأجندات إقليمية متشابكة، تُنسّق في أذربيجان وتُفعّل في الجنوب السوري.
من يحكم دمشق اليوم؟
السلطة الأمنية لا تزال ممسكة بالشوارع، لكنها فقدت مركز القرار.
السفارات الأجنبية باتت تتعامل مع وكلاء ومبعوثين لا يحملون صفة رسمية.
والنخب السياسية التي ليست جزءًا من السلطة، انقسمت بين من يفاوض إسرائيل سرًا، ومن ينتظر صفقة أميركية سعودية إسرائيلية تُعيد تعويم النظام بوجهٍ جديد.
مأزق السلطة المؤقتة
السلطة المؤقتة التي تحكم دمشق الآن لا تمثل دولة، بل جهازًا للتمويه، يخفي وراءه ثلاث حقائق مُرّة:
1. لا مركز للقرار في العاصمة: القرار موزّع بين غرف تنسيق في عواصم الجوار، ومساحات نفوذ تتحكم بها إسرائيل وتركيا.
2. الجيش لم يعد جيشًا وطنيًا: بل فصائل مدججة بالتبعية، بعضها ممول خليجيًا، وبعضها محكوم بقرار تركي.
3. المجتمع السوري ينهار طائفيًا: ليس لأن الطائفية طبيعة السوريين، بل لأنها أصبحت أداة النفوذ الوحيدة لتثبيت الكيانات المفككة.
بين المسرحية والخيانة:
هل نفهم الدرس؟
الاحتلال لا يريد السلام، بل الاستسلام.
هذه الحقيقة تجاهلها الشرع وهو يبعث رسائل إيجابية إلى إسرائيل، ظنًا أن الغصن الأخضر سيغريها بالتراجع.
لكنه نسي أن منطق الاحتلال لا يشتغل بالرسائل، بل بالخرائط.
ومثل أنطوان لحد، كل من ظن أنه يمكن أن يبني مجدًا تحت مظلة الاحتلال، انتهى معزولًا، أو مقتولًا، أو مطرودًا.
فإسرائيل لا تحمي أحدًا… بل تستخدم الجميع.
هل هناك مخرج؟
ما يجب أن يُقال واضح وصريح:
أنا مسؤول. أتحمّل المسؤولية.
أدعو إلى مؤتمر وطني جامع، لا مكان فيه للطائفية، ولا امتيازات، ولا مؤامرات.
نحن بلد واحد، لا يُبنى بالسلاح بل بالقانون، ولا يُحكم بالقمع بل بالحوار.
لكن هذا لم يُقل.
والخطاب، بدل أن يكون وعدًا بمصالحة وطنية، جاء إعلانًا عن فصل جديد من مسرحية الانهيار…
بشعب يصفق للجلاد، ويتلو بيان الهزيمة كأنه نشيد وطني.
رسالة إلى العالم الحر:
إلى كل من لا يزال يراهن على بقاء الدولة السورية، نقول:
إن سوريا تُنتزع الآن من أهلها.
تُختطف رويدًا رويدًا باسم السلام، تُفكّك تحت غطاء ضبط الأمن القومي،
ويُعاد رسمها وفق خريطة مصالح إقليمية لا علاقة لها بالسوريين.
من الساحل إلى السويداء، من عفرين إلى مدينة البعث،
لم يعد السؤال: من يحكم؟
بل: هل بقيت سوريا دولة؟
الجواب ليس في خطاب الشرع، بل في الدم المسفوح
الأرض المستباحة
الهويات التي تتآكل بصمت.
إلى السوريين أنفسهم، نقول:
لا تنخدعوا بالمساحيق ولا بالكاميرات ولا بالمراسم.
السيادة لا تُكتب في بيان، بل تُبنى بالمشاركة،
وتُحمى بالمحاسبة،
وتُصان حين يشعر كل سوري أن له مكانًا في وطنه،
لا كضحية ولا كمتهم.
خاتمة
إن ما يجري في سوريا اليوم هو بداية تشكّل كيان جديد لا يُشبه سوريا.
كيان تفرضه القوى لا الشعوب، وتصنعه الصفقات لا الإرادات الحرة. وإن لم ننتبه الآن… فسيأتي وقت، لن نعرف فيه لمن ننتمي، ولا بأي لغة نحكي، ولا بأي جغرافيا نحلم.

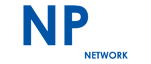

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.