تحولات أميركا في الشرق الأوسط.. من دعم الديمقراطية إلى تأكيد السيادة
نورث بالس
في كل تفصيل من كلمته التي ألقاها في “قمة جدة للأمن والتنمية”، كان الرئيس الأميركي، جو بايدن، يؤكد على أن الاستراتيجية الحديثة للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، صارت قائمة على قطيعة مع ما كانت عليه “استراتيجية ما بعد الحادي عشر من أيلول”، حتى أنه صار يوحي بأن هذه الاستراتيجية الجديدة ستكون مناقضة تماماً لتلك التي كانت.
قبل عقدين من الزمن، وتحت تأثير عوامل ضاغطة متعددة ومتراكبة: من أحداث الحادي عشر من سبتمبر إلى صعود طبقة المحافظين الجدد في السياسة الأميركية، مروراً بالشخصية الخاصة التي كانت للرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، وليس انتهاء بفورة الاقتصاد الأميركي، اتخذت الولايات المتحدة رؤية وبرنامجاً سياسياً استراتيجياً ضخماً خاصاً بالشرق الأوسط، قام أساساً على تشجيع ودعم الديمقراطية: تحويلها إلى قيمة معيارية للعلاقات الأميركية مع قوى المنطقة، وخلق مظلة سياسية كبرى للدفع وحماية القوى المحلية والإقليمية ذات النزعة والمطالبات الديمقراطية.
راهناً، تم التخلي التام عن كل ذلك.
إذ في المبادئ الخمسة التي حددها بايدن خلال كلمته، كإطار وقيمة وأداة قياسية للاستراتيجية الأميركية الجديدة، ثمة تأكيد على “سيادة دول المنطقة”. الأمر الذي يعني فعلياً إلغاء أي فروض أو تدخلات أميركية، أو حتى ملاحظات، فيما خص الأوضاع الداخلية لبلدان المنطقة، ليس فقط في مسائل الديمقراطية والحريات السياسية والعامة، بل حتى فيما يخص قضايا حقوق الإنسان. التي أشار إليها الرئيس الأميركي بشكل عارض، في البند الخامس والأخير من كلمته، وبجملة واحدة فحسب، مستدركاً مباشرة ” الحريات مهمة جداً وضرورية لنا كأميركيين”.
هذا التحول أو الانقلاب في الاستراتيجية الأميركية للشرق الأوسط، من دعم الخطابات والتطلعات والنزعات الديمقراطية، نحو التأكيد على سيادة الدول والأنظمة واستقرارها وهيمنتها على مجالها الداخل، حدث لطَيف من الأسباب، المحلية والإقليمية والدولية، ساهمت جميعاً في خلق التموضع الحالي، حيث من المتوقع أن تتحول إلى بنية تحتية للاستراتيجية الأميركية خلال العقود القادمة، حسب هذه المُعطيات.
فشل المشروع الأميركي في العراق كان على رأس تلك العوامل الدافعة لذلك. الوحل العراقي الذي كان خلال الأعوام (2003-2008) قد خنق كل التطلعات والرؤى الأميركية للعراق، ولكامل الشرق الأوسط.
فالولايات المتحدة كانت تعتقد وقتئذ أن العراق سيكون النموذج أو المثال لما سيحدث ويُنجز في البلدان الأخرى، سيتحول نظامها السياسي القائم على القيم والآليات الديمقراطية إلى منارة تستهدي بها القوى والمجتمعات والتنظيمات الطامحة لتحقيق نماذج موازية في البلدان الأخرى، “نظرية الدومينو” الأميركية الشهيرة وقتئذ.
لم يحدث ذلك قط. فمن جهة أظهرت النُخب السياسية والثقافية، ومعها المجتمعات المحلية العراقية، فشلاً ذريعاً في التبني السريع للآليات الديمقراطية، إذ لم نقل عطباً في ذلك المجال. بدلاً عن ذلك، غرقت في مذبحة طائفية ومناطقية وطبقية كبرى، وأظهرت جاهزية تامة للانسياق في الولاءات وأشكال الاستقطاب والصراعات لصالح هذا الفاعل الإقليمي أو ذاك، مما أحبط التفاؤل الأميركي، داخل العراق أو إمكانية تكراره في البلدانٍ الأخرى.
أعمق ما فعلته التجربة العراقية بالاستراتيجية الأميركية كان خلق إحساس باستحالة أن تكون “الدمقرطة” مشروعاً سياسياً وعسكرياً مفروضاً من الخارج، غير منبعث من طبيعة التحولات داخل هذه الدول والمجتمعات، ونتيجة لصراعاتها وتجربتها الذاتية.
كذلك كانت تجربة العراق درساً لصانع القرار الأميركي في قدرة القوى أو الأنظمة الإقليمية على التعاون الموضوعي فيما بينها، لإفشال أي مشروع أو تطلع لخلق دمقرطة ما، في أي بلد إقليمي آخر كان.
تعاضدت الدول الإقليمية في ذلك، بالرغم من الشروخ السياسية والصراعات الأمنية والمزاحمة الاقتصادية فيما بينها، وأظهرت سلوكاً سياسياً غريزياً معادياً لتلك الدمقرطة، متجاوزاً لأي طبائع أو خصائص أخرى في بنيتها.
لسوء طالع بالغ، تلاقت ذروة الإخفاق الأميركي في العراق مع تحول دراماتيكي في طبيعة النخبة والنزعة “القائدة” للولايات المتحدة: من الحزب الجمهوري المتبني لأيديولوجيات ورؤى المحافظين الجدد التدخلية، إلى عهد باراك أوباما المحافظ سياسياً، الراغب بشدة للانسحاب من “المغامرات” الخارجية، والنازع نحو تحويل الاقتصاد ومنطقة شرق آسيا إلى بؤرتي تركيز رئيسيتين للاستراتيجية الأميركية تجاه العالم، وتالياً التخلي الثنائي المقابل للأمرين: الأيديولوجيا التبشيرية ومنطقة الشرق الأوسط.
جشع الإسلاميين واندثار الآمال التي كانت معلقة على موجة الربيع العربي كانت العامل الثالث والأكثر حيوية فيما طرأت على الاستراتيجية الأميركية من تحولات.
فالربيع العربي أظهر ترابطاً عضوياً بين أي تغيير جذري قد يحدث في أي دولة إقليمية ما، وبين اندلاع الفوضى العمومية. هذه الفوضى التي غدت تؤثر على الأمن القومي للعديد من حلفاء الولايات المتحدة، بالذات دول المنظومة الأوروبية، وغدت تهدد بتفجير سيول المهاجرين والمحبطين، الذين غالباً ما يكونون حطباً لنزعات التطرف، ودون أية معطيات حول إمكانية تجاوزه في الأفق المنظور.
كذلك أثبتت هبّة الربيع العربي أن الإسلاميين هُم البديل الجاهز، وشبه الوحيد، لأنظمة الشمولية السياسية. هؤلاء الإسلاميون الذين أثبتوا في كل مثال فظاعة نزوعهم لنيل السلطة وفرض الأيديولوجيات القمعية على مجتمعات هذه الدول، وتالياً تهيئة الأرضية المناسبة لتراكم التطرف الأيديولوجي والحروب الأهلية المستدامة في مختلف تلك البلدان.
الإسلاميون كان قوة الإعاقة المركزية لإمكانية دمقرطة المنطقة، لأنهم منحوا طرفي الصراع أداتين تحطيميتين لذلك التطلع. فعبرهم صارت الأنظمة الشمولية الحاكمة تملك عصاها السحرية: “إما نحنُ أو المتطرفون والفوضى”. كذلك دفعوا المجتمعات لأن تُكدس مرارات وشعوراً دفيناً بالقرف من أي خطابات أو دعوات لتغيير الأنظمة الشمولية وتشييد البنى الديمقراطية.
في ظلال ذلك، لم تجد الولايات المتحدة أي مكانة لها أو إمكانية لاجتراح ما هو ذو قيمة مضافة من خلال دعم النزعات والقوى الديناميكيات المتبنية للديمقراطية في هذه البلدان.
أخيراً، فإن التحول النوعي في الاستراتيجية الأميركية تجاه الشرق الأوسط ترافق مع زيادة دور ونفوذ وقدرات قوى “إعاقة الديمقراطية”، في المستويين الإقليمي والدولي على حدٍ سواء.
خلال العقدين الماضيين، صعدت روسيا والصين كقوتي مزاحمة للولايات المتحدة، بنظامين قادرين على جذب وحماية الأنظمة والتوجهات المناهضة للولايات المتحدة وخياراتها السياسية، تلك الأنظمة التي، لغير صدفة، هي عكس كل خيار أو خاصية ديمقراطية.
كذلك صعدت القوى الإقليمية ذات نفس النزعة المعادية تلك السياقات الديمقراطية. بعضها راكم ثروات مالية وقدرات اقتصادية هائلة، قادرة على تحويل تلك الأموال إلى فاعل ذو تأثير على مختلف أحداث ودول العالم، فكيف بالأحوال الإقليمية. وبعضها الآخر راكم عدداً هائلاً من الفصائل المسلحة وتنظيمات الشغب، وصارت تتصرف في منطقة الشرق الأوسط كـ”دبٍ في محل لبيع الخزف”.
كل تلك العوامل دفعت الولايات المتحدة لأن تكون أكثر حذراً وأقل أملاً في إمكانية تحقيق قيمة ومنجز ديمقراطي في الأفق المنظور، وصارت تتطلع لأن تكون شديدة الواقعية، وتؤمن في باطن وعيها بأن هذه الأنظمة التي تكرست طوال قرابة قرنٍ كامل، وفي الكثير من الأحيان بدعم من الولايات المتحدة، ليست مجرد بيادق ودُمى، في الرقعة الإقليمية، التي كانت الولايات المتحدة تعتبرها يوماً “مجرد دومينو”.
رستم محمود

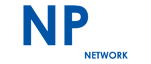

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.